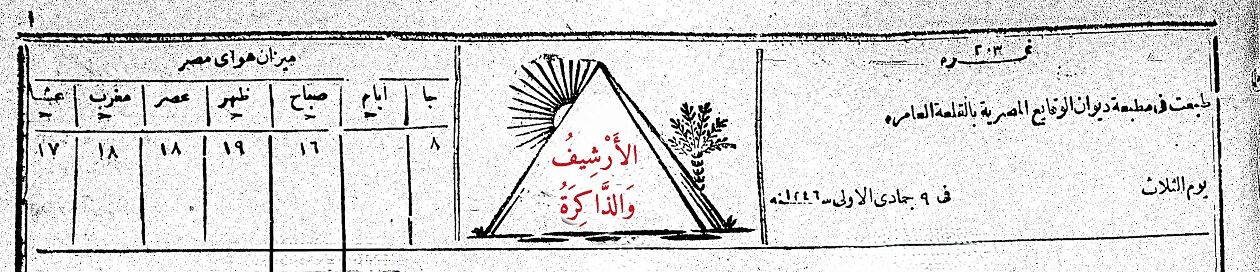كان السجن الذي نزلنا به هو سجن طرة الشهير، وهو ليس سجنًا واحدًا بل مّجمع سجون كبير –ما شاء الله– يتكون من عدة سجون: سجن الاستقبال، سجن التحقيق، عنبر الزراعة، سجن المزرعة.. وكان نصيبنا في البداية في هذا السجن الأخير، وهو الأكثر شهرة بين السياسيين، من بتوع الأفكار وبس ومن غير حاملي السلاح. بينما الجماعات الإسلامية، وأحيانًا الإخوان، حين لا يوجد لهم مكان خاص في سجن آخر، ينزلون بسجن الاستقبال – غالبًا- وهو الأشد القسوة عن غيره في هذا المجمع. والمجمع في الإجمال يطلقون عليه سجن طرة الخمس نجوم، وذلك عند مقارنته بسجون أخرى من عينة سجن وادي النطرون، سجن أبو زعبل، سجن العقرب، والسجن شديد الحراسة.. وغيرها.
وبالفعل نزلنا في بداية الأمر في الجناح الملكي لمجمع سجون طرة، أعني سجن المزرعة، وكان ذلك يعني مزيدًا من الاطمئنان لدينا للأيام المقبلة. كان الأمر يعني هنا أننا لن نشاهد حفلات الاستقبال الشهيرة، بل وأكثر من ذلك، فقد تم صرف تعيين الأكل، رغم أننا وصلنا بعد الخامسة مساءً، أي أننا لم نكن على قوة السجن! بل وأيضًا تم صرف بدلة لكل مواطن سجين، بدلة بيضاء مكتوب على ظهرها باللون الأصفر “مسجون”. كان اللون الأبيض يعني أننا في فترة الحبس الاحتياطي. كانت الملابس نظيفة جدًا كأن لم تمسها يد بشر من قبل! كل هذا جعل الكثير من المتعاطفين المقبوض عليهم معنا يدافعون عن هذه الدولة “دول ناس كويسه أهم، فيه أكل، وهدوم جديدة بأكياسها، ومأمور سجن طيب ومحترم…”. لم ينه الزميل كلمته إلا وجاء شخص ضخم يرتدي ملابس مدنيّة، ومعه ورقة قام بتسليمها للسيد المأمور المحترم. أشار أحد رفاقنا السوابق -أي من معتادي السياسية مرتادي الحبس بسببها- إلى أن هذا الرجل شكله وراه مصيبة بحجم شاربه الضخم. إنه ضابط المباحث بسجن المزرعة (محمد باشا هوجان). كانت الورقة عبارة عن فاكس من مباحث أمن الدولة، بنقلنا إلى ملحق بسجن المزرعة اسمه عنبر الزراعة، وما أدراك ما عنبر الزراعة! لم نكن نعرف عنه ولا نسمع عنه أي شيء قبل أن نزوره، كوفد من الطلبة بتوع السياسة، لا بالتلقين من زملائنا ولا بالمعايشة من قبل. لكن كان كفاية جدًا أن نعرف أن محمد باشا هوجان هو ضابط المباحث هناك، فخبرة الرفاق مع هذا الحيوان “الثديي” وتلك الشهقة التي صدرت عنهم عندما شاهدوا خلقته.. كل ذلك كان كافيًا لأن ندرك أو نتخيل ما هو عنبر الزراعة. إلا أن الملحوظة الجديرة بالتسجيل، هي أن محمد باشا هوجان، ورغم تعامله اللاإنساني مع الطلبة وكأنهم –بالتحديد أعداء الوطن بتاع أمه! لكن للحق وللإنصاف وللتاريخ فقد كان عنفه هذا مجرد نسمة رقيقة وحالمة، بالنسبة لمأمور سجن الملحق وحيد “مش باشا واحد، لأ باشاتان” مزارع، أو كما كان يطلق على نفسه ويحب أن نطلق عليه “الطاغية”. وهو اسم الدلع! وحيد باشا ده هو عبارة عن أثر فرعوني غابر، يتم تحديد طوله وكتلته الإجمالية بالهكتار، أما رأسه وحده فكان ككتلة رأس أبي الهول. كان يرتدي في يده ساعة حائط. وفى قدميه كان حذاء مقاس (100). استقبلنا في هذا اليوم وهو جالس على كرسيه الخاص، عرفنا فيما بعد أنها كنبة ويتم وضعها له كناية عن الكرسي! ورغم أن حفلة استقبالنا في عنبر الزراعة اقتصرت على حلاقة رؤوسنا على الزيرو، فما رأيناه من حفلة استقبال لوفد من المتهمين في قضايا جنائية، كانوا قد وصلوا قبلنا بدقائق، كان كافيًا حتى ترتعد فرائصنا من الذعر. كان طابور الكتل البشرية ممتدًا بما يفوق العشرين شخصًا بنمرة يقفون بملابسهم الداخلية فقط.. ينظرون للحائط، ثم يأمر وحيد باشا أي شاويش بضرب المتهمين بماسورة بلاستيكية ذات لون برتقالي على ظهورهم بلا ترتيب واضح. والعبرة في إنهاء تلك النوبة، تكون بتخدل ذراع الشاويش، وهذا لم يكن يحدث سريعًا أو بسهولة حتى لا يتم عقابه هو، أو على الأقل وصفه أمامنا بأنه “خول”. ولأن الأمر عادة سيكون داخل السجن، أي بعد تلك الحفلة، أكثر سوءًا من ذلك، فإن الجنائيين، سواء السوابق أو أول مرة، كانوا يجلبون معهم حبوبًا وأقراصًا مخدرة حتى تساعدهم على احتمال “طول الليالي.. وولاد الزواني”. وهناك طريقتان مشهورتان جدا في جميع أنحاء السجون المصرية لتهريب تلك الحبوب، الطريقة الأولى، ولها اسم حركي “أَمبُلَة” أما الطريقة الأخرى فهي “الرفع” ويحكي الرواة أنها الطريقة الأكثر شهرة! وهكذا فهمنا فيما بعد لماذا لم يكن تفتيش الجنائيين ذاتيًا بخلع جميع الملابس، أيوه حتى الكيلوت! وحده يكفي.. فقد أجبروهم على تناول سائل يساعد على الإسهال كمرحلة أخيرة في تفتيشهم قبل الذهاب إلى عنابر الإيراد. إلا أنه كانت هناك مرحلة تسبق مرحلة تناول السائل، بحيث لو نجحت لا تكون هناك ضرورة له، وهي وضع (عصاية، سيخ، ماسورة بلاستيك.. أو حتى بأحد أصابع اليد) في فتحات شرجهم ومن يرفض هذا الإجراء يتم ضربه وإجباره على تناول السائل، ويا ويله ويا سواد ليله اللي يطلع معاه حاجة!
**
كان اليوم الطويل، في الواقع يومين ورا بعض بدون نوم، وما رأيناه في حفلة الاستقبال الكريمة، والتفكير في كيفية إدارة الأيام السودا المقبلة، إدارة حكيمة، كان كافيًا لأن “ما نصدق ندخل العنبر”. وللمرة الأولى في تاريخ وحيد باشا مزارع، في عنبر الزراعة، إنه يذهب بنفسه إلى عنبر الإيراد ويقوم بتسليمنا للمعلم سيد جاز نبطجي عنبر 5/1 إيراد. أوصاه بعدم تعَّرض أي من “الأوباش الجنائيين للأفندية، وإلا إنت عارف يا سيد!”. لم يكن في الأفندية نَفَس علشان يفرحوا أو يزعلوا بالأوباش والعيارين والدهماء. ولا حتى يتآلطوا عليهم، “يعني يفضلوا أوباش لحد ما نصحى من نومتنا ونشوف.. وإنا لنائمون”. كان المعلم سيد جاز (اسم شهرته) حرامي سيارات كبيرًا وذائع الصيت، أشهر من نار على علم هنا في السجن. لم يكن يسير في أرجاء العنبر إلا ويداه داخل سرواله ليداعب قضيبه. اقترح علينا أن نأخذ الجانب الأيسر من العنبر. كان كل جانب يحتوي على عدة أسرّة. وطلب من الجنائيين أن يرحلوا بحاجياتهم إلى الجانب الآخر بعيدًا عنا. وحذرهم كثيرًا من أن من سيتعرض لنا فحسابه سيكون عند وحيد باشا مباشرة! يعني هيسمع الندا.
وما إن بدأت الملائكة في التوافد بسلاطين الأرز باللبن! حتى جاء وحيد باشا في الرابعة فجرًا، فتح باب العنبر ودخل الشاويش دبانة أولاً لتمهيد السكة، ونادى بصوت مرتفع جدًا “انتباه! انزل يا ابن القحبة إنت وهو ووشك للحيط وإيدك لفوق”. ثم دخل وحيد باشا بحجة الاطمئنان علينا (الطلبة) وصرف بطاطين ميري لونها أسود وملآنة من خيرات ربنا.. إشي تراب، إشي حشرات، إشي ثقوب كبيرة حبتين. ويبدو أنها كانت من موضة سنة 1948 مثلا. ومع ذلك تعجب الجنائيون لهذا الأمر ومنه ومن الحنية والمعاملة الطرية لنا. في سرهم افتكرونا ناس مهمين في البلد.. “بتوع السياسة صرفوا لهم بطاطين يا جدعان!”. والذي نسيت كتابته عندما دخلنا العنبر -فقد كنت أريد النوم وقتها بصراحة- أننا وجدنا بعض الجنائيين قاعدين في العنبر بالكيلوت فقط! ولم يكن هذا بسبب الحر مثلاً لكن لأن حفلة الاستقبال نزعت عنهم كل ملابسهم غير البيضاء! ففي تأثر واضح بالمدرسة الرمزية، يرتدي كل المحبوسين احتياطيًا ملابس بيضاء باعتبارهم لم يدانوا بعد. أما الذين صدرت ضدهم أحكام بالإدانة سواء بالحبس أو بالسجن، فيرتدون ملابس ذات لون أزرق (مع إن اللون الأسود هو لون الشر المفضل؟!) ويمكن من ساعتها تعلمنا جميعا أن نرتدي كيلوتات بيضاء لفترة طويلة بعد الخروج من الحبس، للطوارئ في حياتنا العادية وتحسبًا لأي ظروف! لم يكن مبرر الاطمئنان ولا صرف البطاطين مقنعًا -دراميًا- لنا بأن يدخل وحيد باشا في هذا الوقت.. فلا هو صاحب قلب طيب، ولا حقوق المساجين مما يهم الداخلية في شيء. لكنه قبل أن يرحل ويتركنا لنعود للنوم، نادى بصوت جهوري (كأنه زئير أسد حصاوي!) على أحد الجنائيين، الذي فيما يبدو نام على نفسه وهو واقف أمام الحائط من التعب وأنزل يديه. اسمه عم طه وكان راجلا كبيرا، أكبر من الستين سنة نفسها، حوالي تمانين سنة تقريبا. لم يقدر على مقاومة نعاسه ولا مقاومة قانون الجاذبية، فأنزل جفنيه وذراعيه لأسفل.. فما كان من وحيد باشا إلا أن طلب من الشاويش دبانة أن يمسك بقدمي الرجل، ويرفعهما في وضع يسمح بالضرب المبرح.. الضرب الذي يفضي إلى إهانة.. و”كسرة نِفس”. لم تكن قدم عم طه مكتوبًا عليها عبارات من قبيل: “اضرب يا جبان!”، “اللي يضربني يبقى مرة!”، “يا ظالمني!” وغيرها من العبارات المتداولة في بطون أقدام الأشقياء هنا.. كانت قدماه فقط تحملان عناء السنين والبهدلة وقلة القيمة في آخر العمر.. كانت شقوقها بحجم وعمق ألم الأيام والليالي. غالبًا لم تكن الخرزانة تؤلمه الألم الفيزيقي! فالأقدام العارية دائمًا أنضجها الزمن حتى ماتت تقريبا.. يا ما داست على حصى ومسامير وأعقاب سجائر مشتعلة وزجاج مكسور وطينة.. أصبح الجلد ميتًا لا يوصَّل إحساس اللمس، ولا حتى الضرب… إلا أن الدموع التي سقطت من عم طه، كانت دموع إهانته وانكساره. ووصلت دموعه للذرورة بما يشبه النحيب، وقال بعد أن قام ووقف على قدميه المنهكتين، قال بانكسار: “أنا هنا مرة واسمي سوسن!” تمامًا كما طلب وحيد باشا منه. وهكذا “شفنا العين الحمرا” ووصلتنا الرسالة الاستباقية. كان المشهد وحده كافيًا لننزل ببرنامج الحد الأدنى في الحفاظ على كرامتنا إلى الحضيض.. وإلى أسفل سافلين كمان. رحل وحيد باشا ومعه الشاويش دبانة عن العنبر، حاولنا أن نقدم بعض التعاطف لعم طه لكن سيد قال “لا مؤاخذة يا أفندية.. ننام بكرامتنا أحسن لنا!”. وفعلاً جاء لبعضنا نوم، إلا أن طلعت وحده أخذ يبكي ويئن بصوت مسموع.. رغم أنه لم يكن من الذين ذهبوا لعم طه ليقدموا تعاطفهم معه.. أخذ طلعت غطاءه وذهب إلى سريره، وكأنه على موعد مع بكائه ويخشى التأخير. أخذ وضع الجنين الباحث عن أمه، وظل يبكي حتى الصباح. لم نكن في حاجة لوقت كبير كي نتعرف على المكان ولكي نتأقلم كذلك معه ومع الناس هنا. بالطبع كانت تلك هي المرة الأولى لدخول معظمنا السجن؛ رغم أن أغلبنا كانوا من طلبة كلية الحقوق! وحده طلعت من كان لا يستطيع أن يضطجع على سريره، قد يكون خوفه الشديد من الإهانة هو السبب.. كان يرتقب دائمًا جرح كرامته، ينتظره كقدر لا يعرف من أين يأتي. كان طلعت انطوائيًا جدًا وخجولاً بأكثر مما قالت عنه منى، كان “كالعذراء في خدرها”. ورغم أن المساجين من ذات المناطق الشعبية الفقيرة التي أتى منها طلعت ومعظم الطلبة المحبوسين كذلك.. إلا أنهم لم يتعارفوا بسهولة. كان ثمة حواجز كثيرة بينهم تحتاج إلى كثير من الوقت حتى تذوب. لم تكن مبادرة الطليعة هذه المرة مثلما فتئ التاريخ يخبرنا، صاحبة الفضل.. بل كانت مبادرة الأوباش الذين عاملونا كتلامذة صغيرين، ووضعوا بعض أسلحتهم البيضاء تحت البطاطين التي ينام فوقها بعضنا .