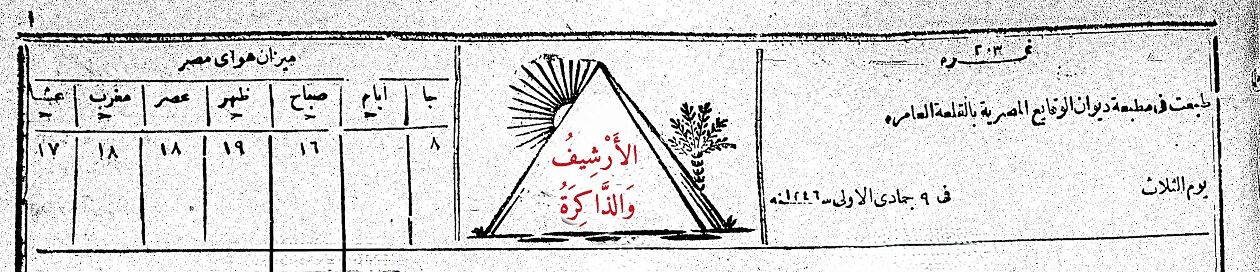مقال جيمس ماريت
ترجمة ماهر عبد الرحمن
نشر في مجلة نيوستيتسمان، يونيو 2025
جيمس ماريت: كاتب عمود في صحيفة التايمز، يُغطي شؤون المجتمع والأفكار والثقافة
نشرت الترجمة للمرة الأولى في موقع Boring books بتاريخ 30 أكتوبر 2025
بدا لي، حين كنت متحمسًا للكتب في سن الثامنة عشرة، أن الأدب الإنجليزي رائد العلوم الإنسانية. وعندما أجريت مقابلة في جامعة أكسفورد وسُئلت عن سبب رغبتي في دراسة الأدب الإنجليزي، أجبت (لا زلتُ أذكر العبارة التي كنتُ قد أعددتها مسبقًا لأستخدمها في تلك المناسبة، وكنتُ أعتقد أنها مؤثرة للغاية) أن “الأدب يُرينا ما يعنيه، أو قد يعنيه، أن نكون بشرًا”، كنتُ أومن بذلك حقًا. كنتُ أشعر، كما وصف (ألفريد) تنيسون، أن أرواح الموتى انعكست على روحي[1] في صفحات الكتب. كانت القصائد، خصوصًا تلك التي كتبها هوبكنز، وإليوت، وأودن، تُؤثر فيّ كما لو كانت تعاويذ. حاولتُ تحميل تسجيل لقصيدة أودن “متحف الفنون الجميلة” على هاتفي المحمول البدائي. وفي المدرسة، كنتُ أقف في ساحة المدرسة وأضع الهاتف على أذني، مغمورًا بسحر الكلمات، مقتنعًا أنني أرد على نداءٍ سامٍ. وإذا كان لا بد من اختزال الأدب في صيغة مبتذلة، فهو التاريخ مضروبًا في الفلسفة مضروبًا في الحياة. كنت أنظر بشيء من الشفقة إلى أقراني الذين اختاروا دراسة “الحقائق المجردة” في الجامعة بدلًا من أن يُستدرجوا إلى “أعماق النفس البشرية الآسرة” (وما زلت لم أتخلص تمامًا من هذه النظرة حتى الآن).
كما يلاحظ ستيفان كوليني[2] في كتابه الجديد الساخر والغني في تناوله لتاريخ التخصص “الأدب والتعلم”، فإن مادة الأدب الإنجليزي تميل إلى إثارة تعلق مفرط نادرًا ما يرتبط، مثلًا، بالجغرافيا أو الكيمياء. ويقول إن نصف مشقة كتابة تاريخ الأدب الإنجليزي تكمن في جمع الإطراءات التي أغدقها عليه معجبوه. بالنسبة للطبقة الأرستقراطية من المثقفين، الذين أدخلوا هذا التخصص إلى الجامعات مطلع القرن العشرين (رجال كانوا يداعبون القصائد كما لو كانت ساعات أثرية، ويصنفون الروائيين كما يصنف الخبراء أنواع النبيذ المعتّق)، كانت دراسة الأدب بمثابة “مجد من أمجاد الكون” أو “النبع الذي يفتح الحياة الخفية”. أما بالنسبة لأتباع الناقد إف. آر. ليفيس والمعلمين المؤثرين في المدارس الثانوية في الستينيات، فكانت دراسة الأدب بمثابة حملة أخلاقية تضع الإنسانية في مواجهة الغزوات القاتلة للروح التي جلبتها الحضارة الآلية.
كان للأدب “قوى تعزز الحياة”، وكانت دراسته ضرورية إذا أراد الإنسان المعاصر أن يحتفظ “بأي قدرة على عيش إنساني”. ويتأفف كوليني بتحفظ على بعض هذه التصريحات المبالغ فيها. وبالفعل، تبدو هذه الإطراءات المبالغ فيها غريبة في عصرنا الذي بات فيه هذا التخصص خجولًا، معتذرًا، ومنكمشًا. اليوم، اختزلت دراسة الأدب الإنجليزي إلى بذل جهد بائس ومرتبك لتقليد العلوم، جهد يطحن الباحثين من خلال إطار التميز البحثي، ويعْد الطلاب بـ “المهارات العملية” القابلة للتطبيق في أي مجال، وهو مفهوم يصعب القضاء عليه، ويُروج له في برامج الدراسات العليا، التي تزعم أن دراسة النقد البيئي في أعمال شيلي المبكرة تُعد تدريبًا مناسبًا لإعداد عروض باوربوينت في شركة برايس ووترهاوس كوبرز (PWC).
مع كل هذه الدعاية النفعية الصارمة على طريقة جرادجرايند[3]، التي تضطر الأقسام الأكاديمية الحديثة إلى تبنيها، يبقى الأمر كما هو: إن تدريس اللغة الإنجليزية في الجامعات يعود في جوهره إلى شغف الناس المفرط بالكتب. ويظل هذا التخصص استثناءً في عالم الأكاديميا فهو تخصص لا يهدف إلى اكتساب المعرفة بقدر ما يهدف إلى اكتساب التجربة الجمالية؛ أي إلى هذا المزج الغريب (كما وصفه كوليني بعبارة موفقة) بين “الجمال والحاشية”. لا يتوقع طلاب الأدب الإنجليزي أن يتخرجوا وهم قادرون على التحدث بلغة أجنبية (باستثناء بعض المفردات من اللغة الإنجليزية القديمة ربما) أو البرمجة، أو حتى التحدث بجدوى عن الاختلافات بين المفصليات والقشريات. ويشير كوليني إلى أنه وفقًا لأدق تصور لهذا التخصص، “ينبغي أن يكون السؤال الأمثل في الامتحان شيئًا من هذا القبيل: أليس هذا جميلًا؟”. مع أن “طريقة الحصول على درجات عالية لن تكون ببساطة بالإجابة بـ “نعم، إنه جميل”.
هذه المفارقة هي ما شكل مصدر ضعف الأدب الإنجليزي كتخصص أكاديمي، ولكنها كانت أيضًا مصدر قوته كأرقى وأسمى فروع العلوم الإنسانية. كنتُ آخر من تأثر بهذا التقليد الشغوف، فقد رباني والدي، وهو مدرس اللغة الإنجليزية، على اعتبار الأدب الإنجليزي ديانة علمانية، كان شكسبير إلهنا، وكنّا نحتفل بيوم ميلاده سنويًا بتقديم كعكة منزلية الصنع. كان منزلنا، كمنزل الريفيين الكاثوليك، مليئًا بالتحف الدينية المبتذلة: أكواب وشراشف ومناشف مطبوع عليها صور شكسبير. كنا نقتبس من شكسبير، ومن شعراء آخرين أمثال (وليام) وردزورث وتنيسون وملتون، كما نقتبس من الكتاب المقدس. وفي عطلات الصيف كنا نتوجه في رحلات دينية إلى مزاراتهم: كوخ دوف، ومسرح جلوب، وستراتفورد أبون آفون[4]. أثار إعجابي والدي حين أخبرني أن أحد أصدقائه صد يومًا متسللًا إلى منزله بنزوله الدرج في الظلام حاملًا شمعة مضيئة وهو يقرأ مقطعًا مؤثرًا من “الفردوس المفقود”، وكانت خلاصة القصة: هذه هي قوة الشعر المرسل.
إذا كان الجو المشبع بعبادة شكسبير المتعصبة، يبدو قديمًا في بداية الألفية، فإنه اليوم يبدو بدائيًا كحضارة آشور، فالاهتمام بالأدب الإنجليزي يشهد تراجعًا حادًا. فبعد أن كان من أكثر مواد الثانوية (A-level) شعبية عندما أنهيتُ المدرسة عام 2011، لم يعد ضمن العشرة الأوائل، بعدما أزاحته مواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، والدخلاء المبتذلون: علم الاجتماع وعلم النفس، ويتم إغلاق قسم الأدب الإنجليزي في إحدى الجامعات تقريبًا كل عام. أصدقائي الذين تابعوا مسارًا أكاديميًا في هذا التخصص – ولا توجد فئة أشد خيبة وانكسارًا منهم – يشعرون أنهم ورثة إرث محطَّم، كانوا يستعدون لامتلاك قصور عظيمة للمعرفة، فإذا بهم يجدون النوافذ محطمة، والأثاث نُهب، والكهرباء قُطعت. جزء من المشكلة يكمن في رسوم الدراسة، لكن الأهم أن الأدب بات هامشيًا ثقافيًا، الشاشة تحل محل الكتاب. وتشير الدراسات إلى انخفاضات دراماتيكية وغير مسبوقة في معدلات القراءة والكتابة، خصوصًا بين المراهقين. وجد استطلاع رأي حديث أن وقت القراءة وصل إلى أدنى مستوى تاريخي. في هذا الجو، لم يعد من البديهي أن يكرّس المرء ثلاث سنوات حاسمة من شبابه لدراسة الأدب. وإذا صدّقنا سيل التقارير الصحفية المنتشرة التي تتحدث عن “نهاية تخصص الأدب الإنجليزي” وأن “طلاب الجامعات النخبوية غير قادرين على القراءة”، فإنه حتى الطلاب الذين يختارون دراسة الأدب الإنجليزي يعجزون فعليًا عن دفع أنفسهم لقراءة الروايات حتى نهايتها. “معظم طلابنا يعانون من أمية وظيفية (المهارات الأساسية للقراءة والفهم)”، وقد وصف لي أكاديمي شاب من أوكسفورد أو كامبريدج مؤخرًا ما يحدث بأنه “انهيار في القدرة على القراءة والكتابة” بين طلابه.
لم يكن أوائل معارضي تدريس الأدب الإنجليزي قلقين من صعوبة قراءة الروايات، بل من سهولتها المفرطة، فعندما دخل الأدب الإنجليزي إلى الجامعات (في أكسفورد عام 1894 وفي كامبريدج عام 1914)، اعترض الأساتذة المحافظون لأنها لا تُعطي الطلاب “التمرين الذهني” الذي تغرسه دراسة الرياضيات أو الكلاسيكيات، وكان آخرون يخشون أن يشجع الأدب الطلاب على أن يكونوا “مضللين وسطحيين”، وهل يحتاج أحد إلى تعليم ليتعلم كيف يقرأ القصائد؟
لم يكن السادة الأدباء الذين استُدعوا أول مرة من فوضى شارع جروب[5] (في لندن) المعروف بصراعات كتّابه وصحفييه، لتأسيس الأدب الإنجليزي في أروقة الأكاديميا نماذج مطمئنة دائمًا للصرامة والدقة العلمية. كان آرثر كويلر كوتش، أول أستاذ للأدب الإنجليزي في كامبريدج، معتادًا على مخاطبة جمهوره من الطالبات بعبارة “يا سادة”! أما جورج سينتسبري، ملك نقاد الأدب في أواخر القرن التاسع عشر، فكان يجمع بين قبوه المليء بالنبيذ، وتطرّفه في الولاء لحزب المحافظين (التوري)[6]، ولحيته الكثيفة، وإلمامه شبه الكلّي بتراث بلاده الأدبي، فكان يحقق ما يعادل 190 ألف جنيه إسترليني سنويًا (بحسابات اليوم) من الصحافة الأدبية، قبل أن يُعيَّن أستاذًا جامعيًا. وقد ساعده على ذلك استعداده المرح لكتابة “ما يصل إلى خمس مراجعات” للكتاب الواحد. أما كتبه التي لا تُحصى (تاريخ الأدب الإليزابيثي، تاريخ الأدب في القرن التاسع عشر، تاريخ العَروض الإنجليزي من القرن الثاني عشر حتى يومنا هذا[7]، وتاريخ مختصر للأدب الإنجليزي في 800 صفحة) فقد مزجت بين الطموح الموسوعي وعدد لا يُستهان به من الأخطاء، وبيع منها عشرات الآلاف من النسخ.
لم تكن مسيرة سانتسبري إلا تجليًا مزدهرًا استثنائيًا لمجتمع كان فيه الأدب الإنجليزي محوريًا ثقافيًا إلى درجة يصعب إدراكها اليوم، وهو ما يُلقي ضوءًا صارخًا على أزمة التهميش التي يعيشها هذا التخصص في الوقت الحاضر. وُلد الأدب الإنجليزي كتخصص أكاديمي في سياق كانت فيه المجلات والصحف تنشر “سيلًا لا ينضب من المقالات النقدية التي تحتفي أو تعيد النظر في إنجازات الشعراء الكبار والصغار على حد سواء”. بالنسبة لكثيرين، كانت “العلاقة الحميمة العميقة مع الشعر الإنجليزي حضورًا حيًا، لا مجرد تظاهر اجتماعي أو بقايا تعليم نصف منسي”. وعندما ألقى جون بيلي، الأديب الذي تحول إلى أستاذ جامعي، محاضرات عامة بعنوان “هل نستطيع التمييز بين الكتب الجيدة والسيئة؟”، و”شيلي”، خاطب قاعات مزدحمة بمئات الأشخاص، كثير منهم واقفون، وحقق نجاحًا باهرًا؛ وعندما تناول الغداء مع رئيس الوزراء السابق آرثر بلفور عام 1914، تبادل الرجلان الحديث عن درايدن، وبوب، وبراوننج، وغيرهم.
كما يكتب كوليني، فإن الحماسة التي أظهرها رجال مثل جون بيلي مكّنت الأدب الإنجليزي من أن ينهل من معين عميق من التكريس والاعتراف الثقافي. وقد بلغ هذا التخصص أوج مكانته خلال العقدين التاليين لعام 1945. في تلك الفترة، حين اكتسب الأدب الإنجليزي المكانة والغاية التي تميز بها كحقل معرفي حديث. أما الغموض المستمر بشأن الغاية الفعلية من دراسة هذا التخصص، فقد ترك فراغًا ملائمًا لادعاءات طموحة. بالنسبة لإي. آي. ريتشاردز، الأب المؤسس للنقد الأدبي التطبيقي، كانت دراسة الأدب بمثابة علم تجريبي يُفحص فيه النص بدقة تحت مجهر الناقد؛ بينما نظر إليه ليفيس على أنه شكل من أشكال الدين غير التقليدي. وقد أضفى الطابع السائد من الجدية الأخلاقية العالية “استكشاف روحي يتقاطع مع مصير الحضارة ذاتها[8]“، كما لخّص تيري إيجلتون ذات مرة رؤية ليفيس لدراسات الأدب، مما منح الأدب الإنجليزي هالة كاريزمية لم يضاهها أي تخصص أكاديمي آخر، لا قبله ولا بعده.
أقرب تماثل لمكانة الأدب الإنجليزي “بوصفه التخصص المركزي” خلال العقود المفعمة بالنشوة التي شهدت أوج ازدهاره، ربما يكون المكانة التي كانت حظيت بها الكلاسيكيات في القرن التاسع عشر، فبينما كانت اللاتينية واليونانية آنذاك أوعيةً لموضوعات المصير الإمبراطوري والتفوق الثقافي الغربي، وهي القيم التي اعتزت بها النخبة الفيكتورية، تزامن ازدهار الأدب الإنجليزي مع ذروة الليبرالية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. في كتابه “الخيال الليبرالي” الصادر عام 1950، والذي صدر في ذروة تلك اللحظة بالذات، جادل ليونيل تريلينج بأن الأدب، من خلال تجسيده لتعقيدات الأخلاق الإنسانية وتشجيع القراء على التقمص الوجداني لوعي الآخرين، يمكن أن يساهم في بناء مواطنين متسامحين، مستقلّي التفكير، وناضجين أخلاقيًا، وهم المواطنون الذين تحتاجهم الديمقراطية الليبرالية لتنجح. لقد كان الأدب الإنجليزي بمثابة حصن منيع ضد التهديدين الرئيسيين اللذين أرّقا ضمير المؤسسة الفكرية في خمسينيات القرن الماضي: الأيديولوجيات الشمولية للكتلة الشرقية، والإمبراطورية المتضخمة لثقافة الاستهلاك الجماهيري التي تهدد الحرية الفكرية. ولم يكن ما حرّك مآخذ ليفيس الحادة لأشكال الترفيه الإلكتروني الجديدة مجرد نفور رجعي من الحداثة، بل التزام ليبرالي عميق باستقلالية العقل البشري، وهي انتقادات تبدو اليوم نبوئية أكثر من أي وقت مضى، حيث تدفع تلك الوسائط إلى استسلام ذهني في حالة من التلقي المنوَّم لأرخص النداءات العاطفية.
الطلاب الذين تدفقوا عبر بوابات الطوب الأحمر وتصاميم الخرسانة الحداثية في مانشستر ويورك خلال الستينيات لحضور محاضرات عن “الإنجليز الأوغسطيين[9]“، ما من شك أنهم كانوا يستجيبون لنداء الفن العالي والواضح، لكنهم أيضًا انجذبوا إلى النداءات الصاخبة للمكانة الاجتماعية، فقد كان النقاد الأكاديميون في ذلك الحين بمثابة نجوم للمشهد الثقافي، وانحنت لهم الثقافة آنذاك. وكما يكتب أحد المؤرخين الذين يقتبسهم كوليني: “لا مبالغة في القول إنه في أواخر الأربعينيات وأوائل الخمسينيات، كان أروع ما يطمح إليه الشباب الأكثر عصرية، حتى بين أولئك الذين بدأوا ينتمون إلى حركة البِيت[10]، هو أن يصبحوا مثل تي. إس. إليوت أو إدموند ويلسون، كان النقد الأدبي بمثابة حجر الفلاسفة[11]. وفي الولايات المتحدة خلال خمسينيات القرن الماضي، كان من الممكن مشاهدة برنامج تلفزيوني منتظم يضم ليونيل تريلينج، وجاك بارزون، ودبليو. إتش. أودن.
تراجعت مكانة الأدب تراجعًا حادًا منذ ذلك الحين؛ بالنسبة لكثير من طلاب القرن الحادي والعشرين، لا يبدو الأدب الإنجليزي تخصصًا ليبراليًا، بل تخصصًا معاديًا للديمقراطية، بما ينطوي عليه من تراتبيات ثقافية، ومرجعيات متداعية، وتبجيل مفرط لكتابات رجال بيض راحلين، فإذا كان التعاطف مع شخصية جين إير[12] يومًا ما يدل على اتساع دائرة الاهتمام الأخلاقي، بما يعزز شعور الفرد بالانتماء إلى الإنسانية جمعاء، فإنه اليوم يُعد ارتباطًا بثقافة نخبوية قمعية. وقد ساهم صعود وسائل الإلهاء الإلكترونية في زيادة ضعف موقع هذا التخصص من الناحية السياسية، فدراسات الأدب الإنجليزي اليوم أبعد ما يكون عن التيار الثقافي السائد، وكلما قلّ عدد من يقرأون أعمال تشارلز ديكنز وجورج إليوت، بدا موقعهما الرفيع في المتن الأدبي وكأنه مؤامرة من نخبة المؤسسة الأكاديمية، لا حقيقة بديهية يتفق عليها جميع الأشخاص العقلاء.
يكتب كوليني: مع مرور الوقت، “قد يصبح من الممكن أن يُنظر إلى المرء على أنه شخص مثقف (أيًا كان المعنى الذي سيحمله هذا المصطلح العتيق حينها) دون أن تكون لديه أي معرفة بالأدب المكتوب قبل عصره، أو ربما بأيّ أدب على الإطلاق”. وأنا أتفق معه، لكن مع تحفظ واحد: “قد يصبح ممكنًا؟” فبالنسبة لأي شخص دون الأربعين، من الواضح أن ذلك الزمن قد حلّ بالفعل، يبقى أن نرى ما إذا كان هذا يُنذر بكارثة — باعتبار أن مصير الأدب يتقاطع مع مصير الحضارة، فذلك ما سيكشفه المستقبل. لكننا نحن الذين نشأنا على الإيمان، حين نتأمل ظلام العالم الحديث، يصعب علينا أن نُبعد هذه الفكرة عن أذهاننا.
[1] – جزء من قصيدة “في ذكرى آ. هـ. هـ. توفي عام 1833”: كلمةً بعد كلمة، وسطرًا بعد سطر، لامسني الرجل الميت من الماضي، وفجأة، بدا لي أن روحه الحية قد توهجت على روحي.
[2] – أستاذ فخري في الأدب الإنجليزي وتاريخ الفكر في جامعة كامبريدج. من بين مؤلفاته: “ما هو دور الجامعات؟” و”حديث عن الجامعات”، و “الأدب والتعلم: تاريخ الدراسات الإنجليزية في بريطانيا”، وهو محور هذا المقال وصدر عن مطبعة أكسفورد 2025.
[3] – “توماس جرادجرايند” شخصية من رواية تشارلز ديكنز Hard Times تمثل رمزاً للفكر النفعي الصارم.
[4] – مسقط رأس وليم شكسبير في الريف الهادئ لمقاطعة وارويكشاير
[5] – شارع غروب (Grub Street)، كان اسما لشارع صغير في حي مورفيلدز (Moorfields) بلندن في القرنَين السابع عشر والثامن عشر، اشتهر برخص السكن فيه فكان مأوى للكتّاب والصحفيين والشعراء والمترجمين الفقراء الذين يكتبون بسرعة مقابل أجر زهيد. ومع مرور الوقت صار الاسم رمزاً للكتابة التجارية والأدب الجماهيري والصحافة الصفراء.
[6] – الحزب التوري: التسمية التاريخية للحزب المحافظ البريطاني (Tory).
[7] – توجد قراءات نقدية جادة تتناول عمل جورج ساينتسبري الموسوعي وأخطائه المنهجية، منها على سبيل المثال مقال لمايكل د. هيرلي المنشور في مجلة Essays in Criticism، المجلد 60، العدد 4، أكتوبر 2010، الصفحات 336–360، بعنوان ” تاريخ جورج ساينتسبري للعَروض الإنجليزية”، الرابط: https://academic.oup.com/eic/article-abstract/60/4/336/496657
[8] – تيري إيجلتون، كتاب “نظرية الأدب” – اقتباس عن صعود اللغة الإنجليزية، “كان من المجزي معرفة أن كونك طالبًا إنجليزيًا لم يكن قيمًا فحسب، بل كان أهم أسلوب حياة يمكن للمرء أن يتخيله – وأن المرء كان يساهم بطريقته المتواضعة في إعادة مجتمع القرن العشرين إلى الوراء باتجاه المجتمع “العضوي” لإنجلترا في القرن السابع عشر، وأنه كان يتحرك في أكثر قمم الحضارة تقدمًا”.
[9] – الأدب الأَوغسطي: مرحلة أدبية في بريطانيا امتدت من أواخر القرن السابع عشر إلى منتصف القرن الثامن عشر، اتسمت بمحاولة واعية لتقليد النموذج الكلاسيكي للأدب الروماني في عهد الإمبراطور أوغسطس. من أبرز ممثلي هذا العصر، جون درايدن، ألكسندر بوب، وجوناثان سويفت.
[10] – حركة البِيت: حركة أدبية وثقافية أمريكية ظهرت في أواخر الأربعينيات وازدهرت في الخمسينيات.
[11] – الحجر الذي يُحوّل كل شيء إلى ذهب.
[12] – الشخصية الرئيسية في رواية “Jane Eyre” للكاتبة الإنجليزية شارلوت برونتي.